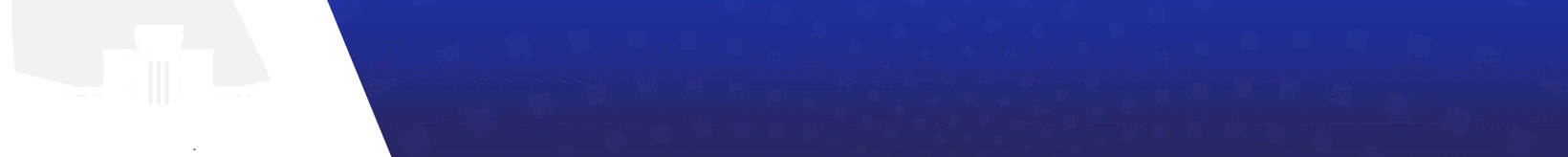لماذا السلام غير ممكن مع الحوثيين؟

محمد الجرادي
تشكل جماعة الحوثي إشكالية فريدة في سياق الصراعات الحديثة، ليس بسبب تعقيدات الوضع اليمني وحسب، بل لتناقض جوهري بين طبيعتها ككيان عقائدي عسكري ومتطلبات أي عملية سلام تقليدية. فالحوثية ليست حركة تمرد عابرة تسعى للسلطة أو للمطالبة بحقوق فئوية، بل مشروعا ايديولوجيا مغلقا يرفض فكرة الدولة بمفهومها الحديث، ويعيد تعريف مفاهيم الشرعية والسلطة والسلام وفق رؤية تستمد وجودها من استمرار الحرب.
هذا التعقيد لا ينبع من عوامل سياسية أو عسكرية ظرفية، بل من بنية ذاتية تستند إلى أربعة اركان متشابكة: عقيدة دينية مطلقة، وبنية وظيفية قائمة على الحرب كبيئة للتكاثر، واقتصاد ظل يعتمد على الفوضى، ووظيفة جيوسياسية كأداة في الاستراتيجية الإيرانية الإقليمية.
تنطلق شرعية الحوثيين من تأويل متطرف للمذهب الزيدي، يحول الحكم من مسالة سياسية قابلة للتداول الى حق الهي حصري في سلالة الهاشميين، وفق مفهوم الولاية في البطنين الذي يجعل السلطة امتدادا لتفويض سماوي لا يخضع للمساءلة.
هذا النسق العقدي – المدعم بمناهج تعليمية ودورات ثقافية الزامية – ينتج وعيا جمعيا بقدسية الحكم، ويجرم فكرة التعددية السياسية، حيث تعتبر المشاركة في السلطة خروجا عن الولاية. تجلى هذا المنطق بوضوح في اتفاق السلم والشراكة الوطني عام 2014، عندما استخدمت الجماعة التوقيع على الاتفاق كغطاء لاحتلال صنعاء عسكريا، معلنة بذلك ان التفاوض ليس سوى تكتيك مرحلي لتحقيق الاستيلاء الكامل على الدولة. لم يكن هذا الانزياح مجرد خيانة للاتفاق، بل تعبيرا عن رؤية تجير الدين لخدمة مشروع يرفض فكرة تقاسم السلطة جوهريا، ويعتبر أي تسوية سياسية تفريطا في عهد إلهي.
لا تقف العقيدة الدينية عند حد رفض التعددية، بل تمتد الى تأسيس سردية دائمة عن الاصطفاء الإلهي، تقدم الجماعة كحامل وحيد للحقيقة ومنقذ للشعب من الظلم. هذه السردية – التي تروج عبر خطاب ديني مجيش – تحول الصراع من نزاع على الموارد أو السلطة إلى معركة وجودية ضد الاخر الكافر، سواء كان النظام السعودي أو الحكومة اليمنية الشرعية. وبينما تعلن الجماعة دفاعها عن المظلومية الطائفية، فإنها تعمل في الواقع على تعميق الانقسام المجتمعي عبر فرض ضرائب غير قانونية باسم المجهود الحربي، وتحويل المساعدات الإنسانية الى سلعة تباع في الأسواق السوداء، واستغلال أزمات المدنيين كالمجاعة وانهيار الخدمات الصحية كادوات للضغط السياسي. وهكذا، تنتج الجماعة ازماتها الخاصة، ثم تقدم نفسها كمنقذ وحيد قادر على حلها، في حلقة مفرغة تعزز تمسكها بالحرب كوسيلة لترسيخ الشرعية.
والمفارقة تكمن هنا في ان الحوثيين لا يستخدمون العنف كوسيلة للوصول الى السلطة، بل يعتمدون على الحرب كبيئة ضرورية لاستمرارهم. فمنذ أول تمرد مسلح في صعدة عام 2004، تطورت الجماعة من مجموعة محلية إلى كيان عابر للحدود، مدعوم بتدريب وتسليح إيراني، يحول كل أزمة إلى فرصة للتوسع.
يعتمد هذا النموذج على دمج المؤسسة العسكرية بالدينية، حيث يخضع المقاتلون لدورات ثقافية تلقنهم تأويلات دينية متطرفة، بينما يتم تدريبهم عسكريا على تقنيات حرب العصابات.
هذه الآلية تخلق هوية مركبة تجعل الولاء للجماعة هوية وجودية تتجاوز الانتماء الوطني، وتنتج جيلا جديدا من المقاتلين الذين يرون في الحرب طريقا للخلاص الفردي والجماعي.
وفي الوقت نفسه، ترفض الجماعة فكرة احتكار الدولة للعنف المشروع، حيث تحتفظ بجيش مواز لا يعترف بسلطة المؤسسات الرسمية، مما يجعل نزع سلاحها – شرط اي سلام دائم – مستحيلا دون المساس بجوهر كينونتها.
لا يمكن فهم تعنت الحوثيين دون الغوص في اقتصادهم الموازي، الذي تحول من نشاط تمويلي بسيط الى شبكة معقدة تدر مليارات الدولارات.
يعتمد هذا الاقتصاد على ثلاث حلقات رئيسية: الأولى تتمثل في الدعم الإيراني المباشر عبر تزويد الجماعة بالوقود المجاني الذي تعيد بيعه في السوق اليمنية، مع فرض ضرائب حرب على التجار المجبرين على الشراء منها. الثانية تكمن في السيطرة على موارد الدولة، حيث تحتكر عائدات المنافذ الجمركية – كميناء الحديدة – وتعيق صادرات النفط التابعة للحكومة الشرعية عبر استهداف البنى التحتية. الثالثة تتعلق بتحويل المساعدات الإنسانية الى سلعة، حيث تسيطر الجماعة على سبعين في المئة من المساعدات الدولية – وفق تقارير اممية – وتفرض رسوما على توزيعها، أو تحرف مسارها نحو مناطق نفوذها.
هذه الشبكات لا تمول الحرب فحسب، بل تنشئ طبقة من المستفيدين المرتبطين عضويا باستمرار الصراع، مما يعقد أي محاولة لإدماجهم في اقتصاد دولة خاضع للمحاسبة.
يتجاوز دور الحوثيين الحدود اليمنية ليكون جزءا من الاستراتيجية الإيرانية الرامية الى إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة. فطهران – التي تقدم الجماعة كجزء من محور المقاومة – تستخدمها كأداة لضرب المصالح السعودية عبر استهداف المطارات والمنشآت النفطية، وتعطيل الملاحة الدولية في باب المندب، دون تحمل تبعات المواجهة المباشرة. كما ان إطالة امد الصراع يحقق لإيران هدفين متلازمين: استنزاف الخصوم الإقليميين، ومنع قيام حكومة يمنية مركزية قادرة على تطويق النفوذ الإيراني. هذا الدور الوظيفي يجعل اي مسار سلام تهديدا مزدوجا: للحوثيين الذين يفقدون اهميتهم كوكلاء اقليميين، ولايران التي تخشى من تحول اليمن الى نقطة ارتكاز معادية لمصالحها.
تكشف محاولات السلام السابقة – كاتفاق ستوكهولم 2018 – عن تناقض جذري: فكل تنازل تقدمه الجماعة (كالانسحاب من الحديدة) يفقدها جزءا من هيكلها الوظيفي، لذا تلجا الى التلاعب بالاتفاقيات عبر حرب قانونية (كالجدل حول تعريف الانسحاب) او افتعال أزمات جديدة (كاستهداف حقول النفط).
هذا النمط ليس تكتيكا مرحليا، بل تعبيرا عن حقيقة ان الجماعة ليست دولة في طور التكوين، بل ماكينة حرب مصممة لتحقيق غايتين فقط: البقاء الذاتي، وتوسيع نفوذ المشروع الإيراني. أي مسار سلام حقيقي يتطلب تفكيك هذه الماكينة عبر نزع الشرعية الدينية المطلقة، وتفكيك شبكات الاقتصاد الموازي، وقطع الدعم الإيراني، وإعادة بناء مؤسسات الدولة خارج الاطار العسكري. لكن هذه الشروط تشكل تهديدا وجوديا للجماعة، التي تعتبر السلام – بمفهومه القائم على الشراكة والمحاسبة – محاولة لنفي ذاتها بدلا عن انتقال الى مرحلة جديدة.
وهنا نخلص الى ان الصدام هو بين نموذجين وجوديين: الدولة القائمة على المواطنة والتعددية، والجماعة القائمة على الاصطفاء الديني واحتكار الحق المطلق. وبينما ترفض الحوثية اي مساومة تمس جوهر مشروعها، تفتقر القوى الدولية والإقليمية الى الإرادة اللازمة لفرض حل جذري يعيد تعريف قواعد اللعبة.
وهكذا، لا يكمن مأزق السلام في غياب الرؤية أو الوساطة، بل في تجاهل السؤال الجوهري: كيف يمكن التفاوض مع كيان لا يرى في الحرب أداة لتحقيق أهدافه، بل جوهر وجوده ومصدر شرعيته الوحيد؟