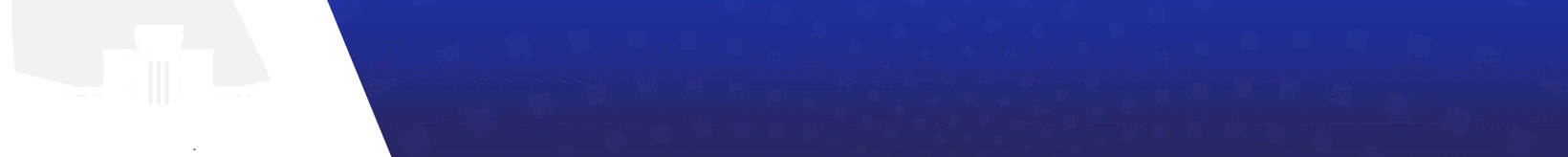لماذا نؤمن بالعلم ولا نصل إليه؟

عبد ربه السقاف الطهيفي
من الأمور التي لا تعرفها المجتمعات العربية عن نفسها، أن من ما يميز العرب هو تقديسهم للعلم والمعرفة، خلافًا لما هو شائع أو راسخ في أذهان الكثيرين.
على سبيل المثال، في أغلب مجتمعات العالم، إذا دار حديث بين مجموعة من الشباب حول ما هو الأهم: مواصلة الدراسة من أجل المعرفة، أو تحقيق النجاح المادي؟ فقد تختلف الإجابات.
لكن في العقل الجمعي العربي، تقفز الإجابة فورًا: العلم أولى، والعلم أهم من المادة. بينما في كثير من الثقافات الأخرى، لا يكون هذا الجواب بديهيًا ولا حاضرًا بتلك السرعة.
بغض النظر عن كون من يقول هذه الإجابة جادًا فعلاً في تفضيله للعلم على أي شيء آخر، أو أنه فقط يقولها لأن العقل الجمعي يفرض قول هذه الإجابة.
كما أن هذا لا يعني بالضرورة أن العرب أكثر اجتهادًا في الدراسة من غيرهم، رغم أن بعض الدول العربية – خصوصًا تلك التي لا تعاني من الحروب – تتفوق فعليًا في معدلات التحصيل الأكاديمي، ويمكن الرجوع إلى إحصاءات منشورة على الإنترنت تؤكد ذلك.
يرسخ في العقل الجمعي العربي أيضًا أن العلم هو أفضل الطرق للنهضة والتقدم، فإذا طرحت السؤال التالي في أي مجلس شبابي عربي شعبي: ما هو الطريق للتقدم؟ فستجد أن الجواب "العلم" يأتي على الفور، وكأنه بديهية فطرية. بينما في مجتمعات أخرى، يُنظر إلى العلم بأهمية، لكنه لا يُمنح نفس القداسة أو المكانة العظيمة الموجودة في نفوس العرب.
وقد يبدو هذا غريبًا، لأن العرب أيضًا لديهم نظرة دونية تجاه أنفسهم في مجال العلم مقارنةً ببقية المجالات.
فهم لا يرون أن هناك من هو أكثر منهم قوة أو كرمًا أو شجاعة أو عراقة، لكنهم في المقابل يشعرون أن كثيرًا من شعوب العالم لديها قدرات فطرية على تحصيل العلم والمعرفة أكثر منهم، وهم مخطئون في كلا الأمرين.
فليست التمايزات بين الأمم بهذه البساطة والوضوح، ولكن هذا موضوع يطول شرحه، وليس هذا مقامه. إنما هذه المسلّمات في العقل العربي تحتاج إلى دراسة لفهم أسبابها ومعالجتها.
والواضح أن ما ينقص الأمة اليوم ليس غياب التقدير للعلم، بل الارتقاء الفعلي بالمستوى العلمي والمعرفي. ولمعالجة هذه الإشكالية الثقافية الاجتماعية، نحن بحاجة أولًا إلى فهم أنفسنا بصدق، كما ذكرت في بداية المقال.
كما نحتاج إلى تفكيك بعض العقد النفسية التي قد تكون عائقًا أمام التثقيف. ولعلّه من الغريب و الصادم لكثيرين أن أقول إن إحدى هذه العوائق هي تقديس العربي للكتاب!
فمن الحقائق الملموسة أن نسبة القراءة في العالم العربي ما زالت ضعيفة جدًا مقارنةً بغيرها من الأمم ذات الحضارات.
وهذا الواقع، حين يقترن بتقديس العربي للكتاب، يؤدي إلى محدودية في مصادر المعرفة؛ إذ يظن البعض أن الكتاب هو الوسيلة الوحيدة، في حين أن الواقع المعرفي اليوم قد تغيّر.
وقد كتبت منذ سنوات مقالًا تحت عنوان الكتاب ليس صنمًا، ناقشت فيه هذه المسألة بطريقة مختلفة.
وعليه، أتمنى أن يعي الشباب الذين يحبون المعرفة والعلم، وفي الوقت نفسه لا يطيقون القراءة، أن الكميات المعرفية التي يمكن أن يكتسبوها من مشاهدة محاضرة جيدة، أو الاستماع إلى بودكاست علمي، أو حتى متابعة فيديو توعوي مختصر، قد تعادل ما يتحصل عليه من قراءة كتاب.
وما يهم في النهاية هو المحصلة المعرفية، لا الوسيلة. فإذا وجدت أن اكتسابك للمعرفة من خلال الفيديو أو الصوتيات أكثر سلاسة ومتعة، فاستمر بها، خاصةً أن الإنترنت متاح، ووقت الفراغ موجود، لا سيما أثناء التنقل أو الانتظار. وحتماً من بدأ بإدمان طلب المعرفة، سيُجرّ إلى عشق الكتب وكل وسيلة معرفية.
وهناك أيضًا ظاهرة جميلة، وهي تزايد مجموعة من الشباب العرب على الإنترنت، خاصةً على منصة يوتيوب، ممن يقدمون ملخصات مبسطة لقضايا علمية مهمة، وتبسيطًا لكتب عميقة ومهمة.
وهذا النوع من المحتوى قد يفتح شهيتك للقراءة أو للغوص في موضوع جديد.
نصيحة مهمة أخرى في هذا السياق، والتي يحتاجها القارئ/المتلقي العربي أكثر من غيره، هي التمييز بين ما هو علمي وما هو أسطوري. وللأسف، نحن لسنا من بين الأمم الأفضل في هذا الباب.
لذلك، لا تقبل المعلومة لمجرد أنها شائعة أو متداولة، أو لأن قائلها يسمي نفسه عالمًا أو مخترعًا أو أي لقب من هذه الألقاب.
كن ناقدًا ومحللًا. فكل معلومة جديدة يجب أن تخضع للتمحيص حتى تثبت صحتها أو تسقط. لا يهم لقب قائلها أو نوع وجهة مصدرها.
وهذا هو منهج الإمام الغزالي – رحمه الله – الذي عبّر عنه في كتابه المنقذ من الضلال، وهو كتاب صغير الحجم، لا يستغرق قراءته أكثر من نصف ساعة، ومتوفر أيضًا بصيغ صوتية على الإنترنت. فيه يسرد الغزالي كيف ترقّى في دروب المعرفة، بأسلوب مؤثر ونافع، يجذب كل من يفهم كلامه.
ونصيحتي الأخيرة: لا تتبنَّ موقفًا فكريًا نهائيًا بعد قراءة كتاب أو سماع رأي واحد.
تذكّر أن كبار الباحثين قرؤوا آلاف الكتب ولم يكتفوا برأي أو مصدر واحد.
لا تتعجل في إصدار الأحكام، فالتسرع في تبنّي موقف ما قد يحرمك من التعمق لاحقًا أو من سماع رأي مغاير.
ابدأ بتزويد نفسك بالمعرفة ولو عشرين دقيقة في اليوم؛ تستمع، أو تشاهد، أو تقرأ في أي مجال يشوقك، وسريعًا سترى النتائج إن شاء الله.