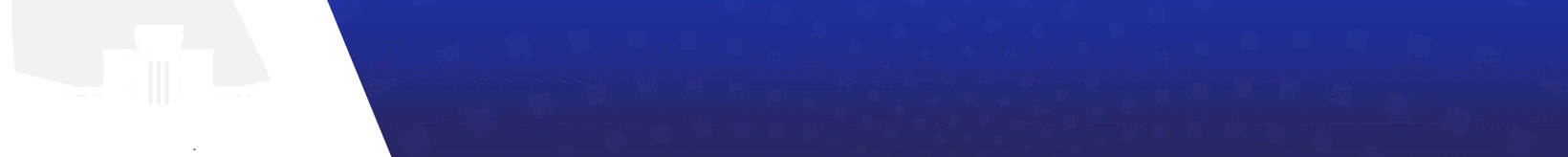الحرب والأخلاق في اليمن.. الحوثي بين خطاب المقاومة وممارسة القمع

توفيق الحميدي
في قلب النزاعات الحديثة، لم تعد الحرب مجرد اشتباك مسلح بين أطراف متصارعة، بل تحولت إلى اختبار أخلاقي عميق للأنظمة، وللحركات، وللقانون الدولي نفسه. فاليمن لا يخوض حربًا عسكرية فحسب، بل يواجه صراعًا وجوديًا حول معنى العدالة، وأسس الدولة، والحدود الفاصلة بين ما هو مشروع، وما هو مجرد تبرير لأفعال لا أخلاقية تُمارس باسم الدين أو المقاومة.
في الفلسفة السياسية، كما في القانون الدولي الإنساني، تُعرف الحرب الأخلاقية بأنها تلك التي تُخاض بدافع مشروع – كالدفاع عن النفس أو حماية المدنيين – وتُدار ضمن ضوابط قانونية وأخلاقية، أبرزها التناسب، والضرورة، والتمييز بين المدنيين والمقاتلين. ليست الحرب الأخلاقية حربًا نزيهة، ولكنها “أقل قبحًا” إن جاز التعبير، لأنها تضبط العنف وتحصره في أضيق الحدود الممكنة، وتمنع تحوّله إلى أداة انتقام أو إبادة.
لكن هل توجد فعلاً حرب أخلاقية وأخرى غير أخلاقية؟ من الناحية النظرية، نعم. ثمة ما يُعرف بـ”الحرب العادلة” التي تستوفي الشروط القانونية والإنسانية، وتقابلها حروب ظالمة كحروب الإبادة أو الاحتلال أو تلك التي تُستباح فيها حياة المدنيين. غير أن الواقع المعاصر أثبت أن جميع الحروب، حتى العادلة منها، تنطوي على مستويات من القبح، ولهذا لم يأتِ القانون الدولي ليبررها، بل ليقلل فظاعتها قدر الإمكان.
وضعت اتفاقيات جنيف، خصوصًا عام 1949، لتقنين الحرب لا إلغائها، وكانت تهدف إلى حماية المدنيين، والجرحى، والأسرى، والطواقم الطبية، ومنع التحوّل الكلي للنزاعات إلى أدوات تدمير شامل. إنها محاولة لأنسنة الحرب، على الرغم من التناقض الصارخ بين الحرب بوصفها عنفًا منظمًا، والإنسانية كمفهوم يقوم على كرامة الإنسان وحمايته.
فلسفيًا، تمثل الحرب لحظة انكسار جوهري للقيمة الإنسانية. إنها النقطة التي تتحول فيها الأجساد إلى أهداف، وتُمحى فيها الفوارق بين الحق والدم. ومع ذلك، قد تحمل بعض الحروب بُعدًا إنسانيًا مشروطًا، إذا خيضت دفاعًا عن المستضعفين أو لوقف عدوان. غير أن هذا البعد لا يصمد كثيرًا إذا ما انقلب السلاح على أولئك الذين زُعم أنهم دافعوا عنهم.
في السياق اليمني، تعود جذور الانهيار إلى 21 سبتمبر 2014، حين انقلبت جماعة الحوثي على الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية. لم يكن الانقلاب مجرد خرق سياسي، بل لحظة انحدار أخلاقي، إذ تجاوزت الجماعة منطق العمل السياسي إلى مشروع هيمنة طائفية مدعوم بالقوة. لم تتوقف عند إسقاط الحكومة، بل شرعت في معاملة اليمنيين بوصفهم أتباعًا، لا مواطنين. مارست القمع، فجّرت منازل الخصوم، أخفت المعارضين، جنّدت الأطفال، وحاصرت المدن، كل ذلك باسم “الثورة” و”الحق الإلهي”.
تتناقض هذه الممارسات كليًا مع المبادئ الأخلاقية والإنسانية، وتنتهك بوضوح قواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يُجرم استهداف المدنيين، وتجنيد الأطفال، ومصادرة الممتلكات، والاعتداء على الكرامة البشرية. ووفقًا لاتفاقيات جنيف، فإن الجماعات المسلحة، حتى وإن لم تكن دولًا، تبقى مُلزمة بعدم ارتكاب مثل هذه الأفعال.
الأخطر من ذلك أن جماعة الحوثي تحاول تبرير سلطتها من خلال خطاب ديني ومقاوم، قائم على “المظلومية” و”الحق التاريخي”، وتوظّف القضية الفلسطينية كغطاء أخلاقي لقمع الداخل. هذا الاستخدام الانتهازي لفلسطين – وهي قضية عادلة بلا شك – لا يُطهّر انتهاكات الداخل، بل يزيدها قبحًا. فمقاومة الاحتلال لا تمنح شرعية لقمع المواطنين، ومن يرفع راية غزة لا يملك مبررًا لقصف تعز.
حين تطلق الجماعة صواريخ باتجاه إسرائيل وتروّج نفسها بأنها حليف للمقاومة، بينما تستمر في حصار مدن يمنية، وتفجير بيوت خصومها، فإنها لا تمارس مقاومة، بل تُعيد إنتاج الاستبداد بشعارات ثورية. فالموقف الأخلاقي لا يُقاس بالشعارات، بل بسلوك من يرفعها.
وفي خضم هذه التناقضات، جاء إعلان الحوثيين منع الملاحة في البحر الأحمر تحت شعار “نصرة غزة” ليفاقم الأزمة الأخلاقية لا ليحلّها. فقد تضرر من القرار اليمنيون أولًا، ثم شعوب القرن الأفريقي، ومصر، وأوروبا، دون أن يُسهم ذلك فعليًا في رفع الحصار عن غزة. لقد تحوّلت هذه الخطوة من فعل مقاوم إلى ورقة تفاوض إقليمي، أُقحمت فيها معاناة الفلسطينيين في حسابات جيوسياسية معقّدة. لا تُنصر غزة بتجويع اليمن، ولا بإغلاق باب المندب، بل بإحياء منطق العدالة، حيث تكون فلسطين والحديدة ومأرب كلها ساحات كرامة واحدة.
ومع خطأ الجماعة، فإن الرد العسكري لا يبرر بدوره الانفلات من الضوابط. فاستهداف المدنيين اليمنيين، أيا كان الفاعل، يُعد انتهاكًا للقانون الدولي، ومخالفة صارخة للشريعة الإسلامية، وانحرافًا أخلاقيًا فادحًا. لا يجيز ميثاق الأمم المتحدة شن الحروب إلا دفاعًا عن النفس أو بتفويض من مجلس الأمن. ولا يجيز العقل الأخلاقي تبرير القتل الجماعي بذريعة الأمن القومي. فكما أن جرائم الحوثي لا تُبرر، فإن الرد الأمريكي المنفلت من الضوابط ليس مقاومة، بل عدوان مغطّى بالقوة.
يسقط الجميع اخلاقيا في اليمن، حين يُقتل طفل، أو يُهدّم بيت، أو يجوع مواطن ، أو يدمر مصدر الرزق باسم السيادة أو العقيدة. لقد سقط الحوثي منذ تمرّده على الدولة، ولا يستره ادعاؤه الانتساب لبيت النبوة، أو رفع شعار فلسطين وغزة ، وسقط مع الحوثي مل شخص و فصائل وكيان شاركت في نصرته في مشروعة التمردي ، أو توجيه السلاح نحو المدنيين الآمنين ، لا أحد يملك مبررًا لقتل يمني لم يشارك في الحرب، أو اعتقالة ، او نهب ممتلكاته ، أو تفجير منزله لمجرد أنه مختلف معه في الرأي .
من منظور القانون الدولي ، والنظرية السياسية للدولة وحدها الحق في احتكار استخدام العنف المشروع، بشرط ألا يتحول إلى أداة قمع جماعي. والتمرد المسلح يُعد خرقًا للنظام الدستوري، يجب علي الجميع أن يقف في وجهها بالأساليب القانونية ، ومع ذلك، لا تقوم العدالة على القوة، بل على الحق والمشروعية الأخلاقية. فإذا تحولت الدولة إلى أداة للإقصاء باسم الأمن، فإن مقاومتها المدنية تصبح مطلبًا أخلاقيًا وحقا دستورياً .
في اليمن، تمثل الدولة، رغم ضعفها، الإطار القانوني المتوافق عليه، في مواجهة تمرد فرض منطقه بالقوة. واستعادة الدولة هنا ليست فقط ضرورة وطنية، بل واجب أخلاقي وقانوني، شرط ألا تتحول إلى انتقام. بل ينبغي أن تُمارس وفق القانون الدولي أثناء الحرب، وتُستكمل بمنطق العدالة الانتقالية بعدها. دولة تُعيد بناء التعدد، وتحمي الحقوق، وتحتكم للعدالة لا للإقصاء.
مثّلت الثورة اليمنية في فبراير 2011 لحظة أخلاقية فارقة في الوعي الجمعي، إذ خرجت جماهير الشعب لا من أجل اقتسام السلطة، بل رفضًا لتحويل الدولة إلى ملكية خاصة تُدار كإرث عائلي، ومطالبةً بدولة مدنية تحترم الإنسان وتصون كرامته. لقد كان جوهر تلك الثورة انتصارًا للقيم: خرجت بوسائل دستورية، حافظت على السلم الاجتماعي، ورفعت شعار الكرامة لا الانتقام، والحرية لا الفوضى. كانت ثورة تؤمن أن الدولة عقدٌ بين المواطنين، لا غنيمة لحاكم، وأن العدالة لا تُولد من فوهة السلاح بل من احترام القانون، وأن السلطة لا تُقدّس، بل تُحاسب. ولذلك، كانت تلك اللحظة تمثل نُضجًا أخلاقيًا في مطالبها، وتعبيرًا نقيًا عن تطلع اليمنيين إلى وطن يحكمه الحق، لا الامتياز، وتُصان فيه إرادة الناس لا تُصادر باسم القوة.
بعد أكثر من عقد على اندلاع الحرب، اختلطت المفاهيم وتشوّهت المعايير، وتراكمت آلام لا تُحصى خلّفها انقلاب الحوثي، حيث قُتل الآلاف من اليمنيين، وشُرّد عشرات الآلاف، ونزح الملايين داخليًا في ظل صمت دولي وتواطؤ إقليمي. ومع تفاقم التدخلات الخارجية وتكاثر مشاريع النفوذ، تعطلت الكثير من مفاهيم العدالة والحق في الوعي العام، لا بفعل العنف وحده، بل بسبب الانحيازات الضيقة، والانتماءات ما دون وطنية، التي أفسحت المجال لأجندات لا علاقة لها بمصير اليمنيين ولا بحلم الدولة الجامعة. بعض القوى منحت نفسها حق التسليح والاعتقال والتعذيب دون سند قانوني، وكأنها تتقاسم الجغرافيا والسلطة باسم الوكالة أو الضرورة، وهو ما يُشكل انتقاصًا خطيرًا لمعنى الدولة، وتهديدًا عميقًا لفكرة العدالة بوصفها مظلة للجميع لا أداة للغلبة. إن ما يُمارس اليوم من انتهاك باسم السياسة، هو في جوهره تفكيك تدريجي لفكرة الدولة العادلة، وتحويلها إلى أطر محلية تابعة لا تملك من السيادة سوى الاسم.
في ظل التطورات الاخيرة ، وقصف ميناء رأس عيسى بالقاذفات الامريكية ، بحجة تجفيف منابع الاقتصاد لجماعة الحوثي ، تاه الموقف بين التأييد المتشفي ، والرافض الخجول ، والرافض تعصبا لا وعيا، وغياب تام للحكومة الشرعية ، رغم أن وزير الدفاع الأمريكي صرّح بأن العمليات لا علاقة لها بالوضع اليمني، بل بمصالح بلاده في البحر الأحمر. كان يُفترض بالحكومة أن تعلن موقفًا واضحا يُذكّر بالقانون الدولي الإنساني، وضرورة التقيد بمبادئه ، ورفض اي استهداف للمنشآت المدنية ملك الشعب ، والانسان اليمني ، حتى لو كانت تفتقر للقدرة الكافية على الرد. فالسكوت هنا ليس حيادًا، بل تفريط في الشرعية ذاتها.
اليمن لا يحتاج إلى حرب إضافية، بل إلى دولة عادلة تملك مشروع إنقاذ حقيقي. فالحرب أرهقت اليمنيين، وساهمت في تمزيقهم، بينما بقي الخطاب الرسمي محصورًا في الهاشتاغات والبيانات. الشرعية لا تكون في الفنادق، بل في صدق الموقف، وفي الدفاع عن المواطن، لا عن المواقع.
وقبل الختام في سياق الحرب التي تسبب بالجوع والانهيار، يُعد الفساد والبذخ الذي يمارسه بعض من يُفترض أنهم ممثلو الدولة وجهًا آخر للسقوط الأخلاقي، لا يقل خطورة عن العنف المسلح. حين يعيش المسؤول في بحبوحة، ويغرق في الامتيازات، ويتنقل بين العواصم، بينما يبيت ملايين اليمنيين على الطوى، فإن هذا ليس خللًا إداريًا فحسب، بل طعن مباشر في مبدأ العدالة الذي يوجب قضاء حوائج الناس والقيام على شؤونهم. إن عجز الدولة عن القيام بدورها، أو ارتهانها الكامل للخارج، أو تفرغها لتقاسم النفوذ، يُحوّلها من كيان راع للحقوق إلى كيان يكرّس الظلم بصمته. فالعدالة ليست فقط محاسبة المجرمين، بل ايضا نصرة الجائع، والوقوف إلى جانب الضعفاء، لا على حواف الموائد الدبلوماسية بل في ملامح الحياة اليومية البائسة.
إن لم نضع حدًا لهذه الفوضى الأخلاقية، فسيبقى العالم يصفّق للقتلة لأنهم رفعوا شعارًا نبيلا، قبل أن يسحبوا الزناد.