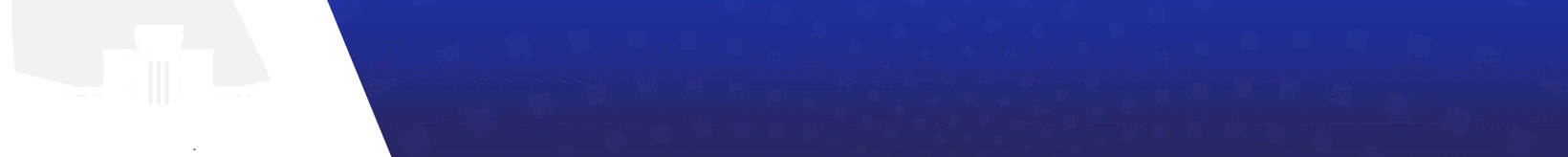ماذا لو نظر الخليج إلى اليمن كما نظرت أوروبا إلى بولندا؟

محمد الجرادي
اليمن والخليج.. الفرص الضائعة والدروس المستفادة من التجربة الأوروبية مع بولندا
في مرات كثيرة، كنت أجد نفسي عالقا في سؤال بسيط ومربك: لماذا لم يُبن اليمن كامتداد طبيعي للخليج؟ هذا السؤال لا يتبادر إلى ذهني وحدي. قرأته مرارا في مقالات لكتاب يمنيين وخليجيين، وسمعته يتردد على ألسنة مسؤولين، ولمحت أثره في وجوه الناس الذين يهاجرون من اليمن وهم لا يفهمون لماذا عليهم أن يبدؤوا من الصفر وهم بجوار أغنى منطقة في العالم.
لقد خطرت في بالي فكرة كتابة هذا الموضوع أو المقارنة بعد أن جمعتني مناسبة أكاديمية في سويسرا بمستشار بولندي/سويسري يعمل في قطاع الاستشارات التعليمية. كان قد عاش فترة التحولات الكبرى في بلده، قبل أن يستقر في زيورخ. وأنا أحرص على الحديث لتطوير لغتي الألمانية، سألته لماذا دعمت أوروبا بلدا لم يكن مهيأ اقتصاديا أو سياسيا، فقال ببساطة: لأن بولندا جزء من أمن أوروبا وكانت مستعدة لأن تُرى، وأوروبا كانت مستعدة لأن تُصدقها.
لقد تركته يكتب لي العبارة كما قالها، وحفظتها في الملاحظات اليومية في الهاتف. ولم انساها.
في مطلع القرن الحادي والعشرين، اختارت أوروبا أن تنظر إلى شرقها بمنطق مختلف؛ فبدلا من التعامل مع دول ما بعد الكتلة الشرقية كمناطق نفوذ أو أسواق مؤقتة، رأت فيها امتداداً استراتيجياً لأمنها واقتصادها. بولندا، التي خرجت من تحت ركام الحرب الباردة باقتصاد منهار وبنية تحتية متداعية، تحولت خلال عقدين إلى قوة اقتصادية صاعدة، بفضل استثمارات أوروبية هائلة وصلت إلى 170 مليار يورو، وإدماجها في سلسلة القيمة الأوروبية. اليوم، بينما يواجه الخليج تحديات وجودية على حدوده الجنوبية، تبرز اليمن كسؤال استراتيجي ملح: لماذا لم تُستثمر إمكاناتها كفرصة جيواستراتيجية، كما فعلت أوروبا مع بولندا؟
الفرق بين التجربتين لا يعود إلى التفاوت في الموارد أو الموقع، بل إلى اختلاف الرؤية. فبولندا، رغم هشاشتها السياسية والاقتصادية في تسعينيات القرن الماضي، لم تُعامل كـ"مشكلة" يجب احتواؤها، بل كـ"شريك" يجب بناؤه. لم تنتظر بروكسل استقرار وارسو لتبدأ الدعم، بل حولت عدم الاستقرار إلى حافز للتكامل
الفرق بين التجربتين لا يعود إلى التفاوت في الموارد أو الموقع، بل إلى اختلاف الرؤية. فبولندا، رغم هشاشتها السياسية والاقتصادية في تسعينيات القرن الماضي، لم تُعامل كـ"مشكلة" يجب احتواؤها، بل كـ"شريك" يجب بناؤه. لم تنتظر بروكسل استقرار وارسو لتبدأ الدعم، بل حولت عدم الاستقرار إلى حافز للتكامل. في المقابل، ظلت اليمن، رغم موقعها الحيوي على باب المندب، وثرواتها الطبيعية الكامنة، وقربها من أغنى التكتلات الاقتصادية في العالم، خارج حسابات الاستثمار الإقليمي طويل الأمد. السؤال الذي يُطرح اليوم ليس عن إمكانية تكرار النموذج البولندي في اليمن، بل عن أسباب غياب الإرادة السياسية لتحقيقه، وعن الثمن الذي سيدفعه الخليج لو استمر في التعاطي مع جاره الجنوبي كتحد أمني عابر بدلاً من شريك استراتيجي.
بولندا.. عندما حولت أوروبا التحدي إلى فرصة
عندما انضمت بولندا إلى الاتحاد الأوروبي عام 2004، كانت معدلات البطالة تتجاوز 19%، وناتجها المحلي الإجمالي لا يتعدى 255 مليار دولار، فيما صنّف 17% من سكانها تحت خط الفقر. لكنّ أوروبا تعاملت مع هذه الأرقام كأعراض لقابلية التطوير، لا كعوائق. تم ضخّ استثمارات هائلة في البنية التحتية، حيث أنفقت المفوضية الأوروبية وحدها 64 مليار يورو بين 2007 و2013 على تحديث الطرق والسكك الحديدية. كما أُنشئت 14 منطقة اقتصادية خاصة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحولت بولندا إلى مركز لصناعة السيارات في أوروبا، باستقطاب شركات مثل فولكسفاغن وتويوتا. الأهم من ذلك، تم دمج مليوني بولندي في سوق العمل الأوروبي عبر فتح الحدود، ما خفض نسبة البطالة إلى 2.9% بحلول 2024.
المفتاح هنا لم يكن حجم الأموال، بل فلسفة الاستثمار. فالأموال الأوروبية ربطت بإصلاحات هيكلية: تحديث النظام القضائي، تعزيز الشفافية، ودعم المجتمع المدني. النتيجة كانت تحوّلاً جذرياً في بنية الدولة البولندية، جعلها حصناً أمامياً لأمن أوروبا بدلاً من أن تكون نقطة ضعف. كما لخص رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق رومانو برودي الرؤية بقوله: "بولندا ليست عبئاً على أوروبا، بل تأمين لمستقبلها".
اليمن.. موارد لم تُستثمر، وموقع لم يوظف
في الجانب الآخر من العالم، تمتلك اليمن مقوّمات قد تفوق ما كانت عليه بولندا: موقعها على مضيق باب المندب، الذي يمرّ عبره 12% من التجارة العالمية، يؤهلها لأن تكون مركزاً لوجستياً عالمياً. كما تمتلك سواحل تمتد 2500 كيلومتر، وموارد طبيعية كالنفط والغاز والمعادن، وقوة بشرية شابة تشكل 70% من السكان تحت سن 25. لكن هذه الإمكانات بقيت حبيسة الصراعات وغياب الرؤية.
المثال الأبرز هو ميناء عدن، الذي كان يُعتبر أحد أفضل الموانئ الطبيعية في العالم، لكنه تحوّل إلى رمز للإهمال. لو حصل على استثمارات مماثلة لتلك التي حوّلت ميناء جبل علي في دبي إلى مركز عالمي، لكان بإمكان عدن أن تستعيد مكانتها التاريخية كبوابة بين آسيا وأفريقيا. كذلك، فإنّ محافظات مثل الجوف ومأرب، التي تحتوي على احتياطيات غازية هائلة، لم تشهد أي مشاريع كبرى رغم الوجود الخليجي القريب. حتى المشاريع القليلة التي بدأت، كمشروع تلال الريان العقاري في صنعاء (بشراكة قطرية)، توقف بسبب عدم الاستقرار، وتحول إلى أطلال، رغم انجاز نصفه بتكلفة 600 مليون دولار.
تمتلك اليمن مقوّمات قد تفوق ما كانت عليه بولندا: موقعها على مضيق باب المندب، الذي يمرّ عبره 12% من التجارة العالمية، يؤهلها لأن تكون مركزاً لوجستياً عالمياً. كما تمتلك سواحل تمتد 2500 كيلومتر، وموارد طبيعية كالنفط والغاز والمعادن، وقوة بشرية شابة تشكل 70% من السكان تحت سن 25. لكن هذه الإمكانات بقيت حبيسة الصراعات وغياب الرؤية.
اللافت أن دول الخليج أنفقت مليارات الدولارات على مشاريع في دول بعيدة جغرافياً وثقافياً في (آسيا وأفريقيا)، بينما ظل الاستثمار في اليمن مقتصراً على المساعدات الإغاثية قصيرة الأجل. لقد بحثت في أرشيف العلاقات الاقتصادية بين اليمن والخليج، ولم أكن أبحث عن قائمة اتهام، بل عن نموذج مُلهم لما يمكن أن يُبنى حين تتوفر الرؤية. وحين دققت النظر، لم أجد أكثر إشراقا من تجربة جامعة صنعاء. ذلك المشروع الذي مولته الكويت في سبعينيات القرن الماضي لم يكن مجرد منحة تعليمية، بل كان استثمارا في عقل اليمن وأجياله، ومستقبله. كليات حديثة، حرم جامعي متكامل، مكتبات، سكن طلابي، لكن هذا المشروع العملاق لم يتستكمل بخطة لتعزيز البنية التعليمية. النتيجة كانت تحول اليمن من جارٍ استراتيجي يمكن أن يُسهم في أمن الخليج، إلى ساحة مفتوحة للتدخلات الخارجية، كما حدث مع توسع النفوذ الإيراني عبر الحوثيين.
لماذا أخفقت الرؤية الخليجية؟
ثمة عوامل متشابكة تفسر الفجوة بين الإمكانات اليمنية والواقع المعاش، لكن العامل الحاسم يبقى غياب الاستراتيجية طويلة الأمد. فدول الخليج تعاملت مع اليمن بمنطق "إدارة الأزمات" بدلاً من "صناعة الفرص". تمّ التركيز على الجانب الأمني (كالتحالف العسكري ضد الحوثيين منذ 2015)، بينما تُركت التنمية كمرحلة لاحقة. لكن التجربة البولندية تثبت أن الاستقرار لا يُفرض عسكرياً، بل يُبنى اقتصادياً.
أحد الأسباب التاريخية هو انعدام الثقة المتبادل. فالدولة اليمنية، خاصة بعد وحدة 1990، لم تقدم بيئة جاذبة للاستثمار بسبب الفساد وعدم الاستقرار السياسي. كما أن بعض النخب اليمنية تعاملت مع رأس المال الخليجي بشكّ، واعتبرته محاولة للهيمنة. في المقابل، رأت الحكومات الخليجية أن المخاطرة باستثمارات كبيرة في بيئة غير مستقرة أمرٌ غير مجدٍ. لكن هذا التبرير يتجاهل حقيقة أن بولندا أيضاً لم تكن "جاهزة" عندما بدأت أوروبا دعمها، بل تم بناء الثقة عبر شراكات ملموسة.
جانب آخر يتمثل في غياب التكامل الإقليمي. فدول الخليج، رغم تكتلها ضمن مجلس التعاون، لم تطرح يوماً مشروعاً تكاملياً مع اليمن يشمل الربط الكهربائي، أو شبكات النقل، أو التكامل السوقي. حتى مشاريع البنية التحتية التي نفذتها السعودية (كجسر الملك فهد مع البحرين)، أو التي تخطط لها (مشروع نيوم)، لم تمدد إلى اليمن، رغم أن مسافة 50 كيلومتراً تفصل بين سواحل المملكة وسواحل اليمن عند مضيق باب المندب.
التكلفة المتصاعدة للتجاهل
تكشف الأزمات الأخيرة أن تجاهل اليمن لم يعد خياراً ممكناً. فالهجمات الحوثية على منشآت النفط السعودية عام 2019، وتعطيل الملاحة في البحر الأحمر، أثبتا أن عدم الاستقرار في اليمن يهدد أمن الخليج مباشرة. كما أن تنامي النفوذ الإيراني في اليمن يحوّله إلى ساحة لصراعات إقليمية، قد تتفاقم مع تغيّر التحالفات العالمية.
الأكثر خطورة هو تحول اليمن إلى بيئة خصبة للتطرف. فوفق تقرير البنك الدولي 2022، يعيش 80% من اليمنيين تحت خط الفقر، ويعتمد ثلث السكان على المساعدات. في مثل هذه الظروف، تصبح الجماعات المسلحة ملاذاً للشباب العاطل، كما حدث مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب سابقاً. المفارقة أن الخليج، الذي خصص 130 مليار دولار لمشاريع التنمية خارج المنطقة بين 2000 و2020، لم يوجّه إلا جزءاً ضئيلا منها لليمن، رغم أن الاستثمار في جارٍ قريب كان سيكون أكثر فعالية من ناحية الأمن القومي.
ماذا لو تعامل الخليج مع اليمن كشريك؟
التجربة الأوروبية مع بولندا تقدم دروساً واضحة:
الاستثمار في البنية التحتية: لو خصص الخليج 10% من استثماراته الخارجية لليمن (نحو 13 مليار دولار)، لتمكّن من بناء ميناء عدن الحديث، وتحديد شبكة طرق تربط الموانئ اليمنية بمدن الخليج، وإنشاء مناطق صناعية في مأرب والحديدة.
تكشف الأزمات الأخيرة أن تجاهل اليمن لم يعد خياراً ممكناً. فالهجمات الحوثية على منشآت النفط السعودية عام 2019، وتعطيل الملاحة في البحر الأحمر، أثبتا أن عدم الاستقرار في اليمن يهدد أمن الخليج مباشرة. كما أن تنامي النفوذ الإيراني في اليمن يحوّله إلى ساحة لصراعات إقليمية، قد تتفاقم مع تغيّر التحالفات العالمية.
التكامل البشري: مع وجود 4 ملايين يمني يعملون في الخليج، يمكن تطوير برامج تأهيل مهني تدمجهم في سوق العمل بشكل رسمي، بدلاً من الاعتماد على النظام الكفيل. كما يمكن إنشاء جامعات مشتركة في اليمن (كالجامعة الأوروبية البولندية للتقنية)، لتعزيز الكوادر المحلية.
الشراكات الاقتصادية: تحويل اليمن إلى شريك في سلاسل التوريد الخليجية، عبر استثمارات في الزراعة (مثل مشروع سلة غذاء في تهامة)، أو الطاقة المتجددة (محطات شمسية في حضرموت)، أو السياحة (تطوير جزيرة سقطرى).
النجاح هنا يتطلب إرادة سياسية. فحتى الخطوات الصغيرة، كإنشاء صندوق خليجي لتمويل المشاريع الصغيرة في اليمن (على غرار صندوق التماسك الأوروبي)، يمكن أن تحدث تحوّلاً في المناطق المستقرة نسبياً مثل مأرب أو المهرة.
الخليج أمام مفترق طرق
التاريخ لا يعيد نفسه، لكنه يقدم فرصا متشابهة. قبل ثلاثين عاما، رأت اوروبا في بولندا تهديدا محتملا اذا تركت فقيرة، وفرصة اذا تم دمجها. اليوم، يواجه الخليج خيارا مماثلا: اما ان يستثمر في تحويل اليمن الى شريك يسهم في امنه وازدهاره، او يدفع ثمن اهماله لعقود قادمة.
الخيار الاول يتطلب جرأة في تبني رؤية جديدة، تعيد تعريف العلاقة من “المانح والمتلقي” الى “الشركاء في المصير”. كما يتطلب الاعتراف بان بناء اليمن ليس عملا خيريا، بل استثمارا في سد الثغرات الامنية والاقتصادية التي تهدد الخليج نفسه. اما الخيار الثاني – الاستمرار في النهج الحالي – فهو وصفة لاستنزاف لا نهائي، حيث ستستمر الازمات اليمنية في تسريب تداعياتها الى الداخل الخليجي، سواء عبر الهجمات المسلحة او الهجرة غير النظامية او انتشار التطرف.
الدرس الاهم من بولندا هو ان الاستقرار لا يمنح، بل يصنع. والخليج، الذي حول الصحراء الى مدن ذكية، قادر على ان يرى في اليمن ما رأته اوروبا في بولندا: جارا يمكن ان يصبح جزءا من الحل، اذا توفرت الارادة لرؤية ما وراء الصراعات القصيرة، والتفكير في مستقبل اقليمي اكثر امنا وازدهارا للجميع.
وقد رأيت بنفسي قبل سنوات، لمحة صغيرة عن الامكانيات التي كان يمكن ان تتحقق لو وجدت تلك الرؤية. بين عامي 2007 و2008، عشت متنقلا بين شبوة جنوب شرق اليمن وحرض شمال غربه بعد ان اكملت دراسة الثانوية. واتذكر انني كنت اشاهد بام عيني نهضة عمرانية استثنائية. كانت حرض خلال تلك الفترة تتحول الى مدينة حدودية نابضة بالحياة بفضل منفذ الطوال، احد المنافذ الحدودية البرية التي تربط جنوب المملكة العربية السعودية مع اليمن، وهو اكبر المنافذ الحدودية بين البلدين. كانت حركة المسافرين والمغتربين والسعوديين تصل الى عشرات الالاف مع نهاية كل أسبوع. كانت حرض في تلك السنوات تمثل نموذجا مصغرا لامكانات اليمن حين تتوافر له الفرصة والحد الادنى من الاستقرار. الاستثمارات تتدفق، الأسواق تعج بالبضائع، الفنادق والمطاعم تتوسع باستمرار. كانت المدينة تتجه لتكون عقدة اتصال اقتصادية رئيسية بين اليمن والسعودية، شبيهة بتجارب عالمية معروفة في المدن الحدودية الناجحة. لكن كل ذلك انهار مع سيطرة الحوثيين على المنطقة. تحولت حرض من بوابة اقتصادية واعدة الى ساحة عسكرية مغلقة، تدمرت البنية التحتية، توقفت حركة العبور، نزح سكانها، وتحطم الحلم الصاعد. اليوم، لم يبق من حرض التي عرفتها سوى اطلال تذكرنا قسوة المآلات حين تختطف الجماعات المسلحة مصير المدن وتغتال فرص البناء والنهوض.
لطالما كانت اليمن نقطة ضعف استراتيجية في منظومة الامن الخليجي. كل من أراد استهداف الخليج، او الالتفاف عليه، مر من بوابة اليمن. ليس لان اليمن عدو، بل لان الفجوة الاقتصادية والسياسية بينه وبين جيرانه فتحت الباب لكل المشاريع المعادية.
بل حتى في التاريخ القديم، كانت اليمن ممرا لكل من طمع بالجزيرة. ابرهة الحبشي حين اراد هدم الكعبة، لم يأت من الحبشة مباشرة، بل جاء عبر اليمن، بعد ان ثبت نفوذه فيها. والاحتلال البرتغالي حين حاول الوصول الى موانئ الخليج، مر اولا من عدن، وكذلك الاستعمار البريطاني الذي بدأ نفوذه في المنطقة من الجنوب اليمني. وفي العصر العثماني، كانت اليمن بوابة استراتيجية في المعارك الكبرى للسيطرة على البحر الاحمر ومداخل الحجاز.
عندما دخل جمال عبد الناصر في صراع مفتوح مع السعودية، اتجه مباشرة الى اليمن، ودعم الثورة، وهذا لا شك كان نقطة في صالحه وصالح اليمن بعد عقود من الظلم والجهل. وحين اراد اليسار العربي تهديد الخليج، دعم الحزب الاشتراكي اليمني بكل ثقله. وفي مطلع التسعينيات، انشأ صدام حسين “مجلس التعاون العربي” كبديل لمجلس التعاون الخليجي، وجعل اليمن بوابته الى الجنوب. وايران، رغم بعدها الجغرافي، لم تتمكن من تهديد امن الخليج بشكل فعلي الا حين وجدت موطئ قدم لها داخل اليمن. حتى الجماعات المتطرفة العابرة للحدود، وجدت في اليمن ملاذا ومسارا للعبور، مستفيدة من ضعف الدولة وهشاشة التنمية.
كل هذه النماذج تقول شيئا واحدا: اليمن ليست مجرد جار مضطرب، بل نقطة ارتكاز حساسة في معادلة الامن الخليجي. التهديد لا يأتي منها بقدر ما يمر عبرها.
والسؤال المطروح اليوم: لماذا تستمر دول الخليج في انفاق عشرات المليارات على التسلح، بينما يمكن اغلاق هذه الثغرة التاريخية بمشروع مارشال اقتصادي؟ كما فعلت اوروبا مع بولندا، حين قررت ان الاستثمار في استقرار الجوار افضل من مواجهته بالسلاح الى الابد.
بناء يمن مستقر لا يعد منة، بل استثمارا طويل الاجل في الامن الخليجي نفسه. فإما أن ينظر الى اليمن كشريك يبنى، او كفراغ يستثمر من قبل الخصوم… ولا ثالث بينهما.
الدرس الأهم من بولندا ان الاستقرار لا يمنح، بل يصنع. والخليج، الذي حول الصحراء الى مدن ذكية وموانئ تنافس العالم، قادر على ان يرى في اليمن ما رأته اوروبا في بولندا: جارا يمكن ان يكون جزءا من الحل، لا مصدر خوف دائم، اذا توفرت الإرادة لرؤية ما وراء الصراعات القصيرة، والتفكير في مستقبل إقليمي اكثر امنا وازدهارا للجميع.
الواقع اليمني الراهن.. إخفاقات الحكم وشتات المكونات وتداعيات الغياب الخليجي
على مدى العقد الماضي، تحوّلت اليمن من دولة هشّة إلى فضاء معقد من التفكك، حيث لم تعد "الدولة" كياناً قادراً على تجسيد الحد الأدنى من الوظائف السيادية. الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، التي قادها الرئيس عبدربه منصور هادي حتى سبتمبر 2022، لم تتمكن من تحويل الاعتراف الدولي إلى شرعية داخلية، أو تقديم نموذج حكم قادر على إدارة المناطق المحررة من سيطرة الحوثيين. بل إن الأداء الهشّ لهذه الحكومة، سواء في العاصمة المؤقتة عدن أو في المنفى السعودي، حوّل "الشرعية" من إطار جامع إلى عنوانٍ لإخفاق متعدد المستويات.
فشلت الحكومة في تعزيز وجودها المؤسسي حتى في المناطق الخاضعة رسمياً لسلطتها، مثل مأرب والحديدة، حيث تُدار الأمور عبر تحالفات قبلية وعسكرية أكثر منها بهياكل دولة. كما أخفقت في تقديم خدمات أساسية كالكهرباء والمياه، رغم الدعم المالي الخليجي الذي تجاوز 6 مليارات دولار بين 2015 و2022 وفقاً لتقارير الأمم المتحدة. بل إن جزءاً كبيراً من هذه الأموال ذهب إلى رواتب موظفين وهميين أو مشتريات عسكرية لم تُحسّن الوضع الأمني. المفارقة أن هذا الإخفاق لم يكن بسبب نقص الموارد، بل نتيجة غياب الرؤية السياسية، وتراكم الفساد الذي حوّل الدولة إلى شبكة مصالح شخصية.
الأزمة تفاقمت مع تنامي الانقسامات داخل المكونات المحسوبة على "الشرعية".
في هذا السياق، برزت ظاهرة "الشتات السياسي" كمؤشر على انهيار النخبة اليمنية. فمعظم كوادر الدولة، من أكاديميين وإداريين وسياسيين، هاجروا إلى دول الخليج أو أوروبا، تاركين خلفهم فراغاً في الإدارة المحلية. حتى الوزراء أنفسهم يقضون معظم أوقاتهم خارج اليمن، فيما تحوّلت مؤسسات الدولة إلى هياكل فارغة يُدار بعضها عبر تطبيق "واتساب". هذا الفراغ ساهم في صعود مليشيات وقوى محلية تُدار بعقلية الريع، حيث تحوّلت الموارد العامة إلى مصادر تمويل لزعماء الحرب.
اللافت أن هذا التفكك لم يُولِّد ضغطاً دولياً حقيقياً لإصلاح النظام السياسي. فالمجتمع الدولي، بما فيه دول الخليج، تعامل مع الحكومة اليمنية كشريكٍ في الحرب على الحوثيين، دون أن يربط الدعم العسكري بإصلاحات سياسية أو اقتصادية. حتى الاتفاقيات التي رعتها السعودية، كاتفاق الرياض 2019 بين الحكومة والمجلس الانتقالي، لم تُنفذ على الأرض، وتحوّلت إلى حبر على ورق. النتيجة كانت استمرار التدهور، حيث لم يعد المواطن اليمني يرى في "الشرعية" رمزاً للحل، بل جزءاً من المشكلة.
هنا تبرز إشكالية الدور الخليجي، الذي ظلّ يراهن على الحل العسكري كمدخلٍ وحيد للأزمة، بينما أهمل الجانب السياسي والاقتصادي. فالدعم الخليجي، رغم أهميته في مواجهة التمدد الحوثي، لم يُترجم إلى استراتيجية متكاملة لبناء دولة بديلة في المناطق المحررة. لم تُفتح جامعة واحدة في عدن أو مأرب بتمويل خليجي، لم يُنشأ مركز تدريب مهني واحد لتأهيل الشباب، ولم يُطلق أي مشروع تنموي كبير يمكن أن يخلق أثراً ملموساً في حياة الناس. حتى المساعدات الإنسانية، التي تجاوزت 20 مليار دولار منذ 2015، لم تُدار بآليات تضمن وصولها إلى المستحقين، وفق تقرير لبعثة الأمم المتحدة عام 2023.
هذا الغياب الخليجي عن المشهد التنموي ترك فراغاً استغلته قوى إقليمية، مثل إيران لتعزيز نفوذها. بدعمها الحوثيين عسكريا، وكتعويض نفوذ، خصوصا بعد تقلص مساحات نفوذها في المنطقة العربية.
هذه التدخلات، تعكس إدراكاً من القوى المنافسة لأهمية اليمن، بينما ظلّ الملف اليمني في السياسة الخليجية سجين الرؤية الأمنية الضيقة.
التجربة البولندية تقدم هنا مرآةً مفيدة. فبولندا، رغم معاناتها من الفساد بعد سقوط الشيوعية، استطاعت أن تبني مؤسسات جديدة بفضل شروط الاتحاد الأوروبي، الذي ربط التمويل بالإصلاحات. في اليمن، كان يمكن لدول الخليج أن تتبنى نموذجاً مشابهاً، بربط الدعم المالي بخطوات ملموسة: تفعيل النظام القضائي، محاربة الفساد، وبناء إدارة محلية كفؤة. لكن غياب الرؤية الاستراتيجية جعل الدعم الخليجي يتحوّل إلى مجرد "إطفاء حرائق"، دون معالجة جذرية للأسباب التي تغذي الأزمة.
النتيجة هي مشهد يمني معاصر يعيد إنتاج نفسه كدولة فاشلة، ليس فقط بسبب الحرب، بل بسبب عجز النخبة المحلية والشركاء الإقليميين عن تقديم نموذج بديل. فالشباب اليمني، الذي كان يمكن أن يكون ركيزة للتغيير، يعيش اليوم في حالة انفصالٍ كامل عن الدولة. 72% منهم يفكرون في الهجرة وفق استطلاع أجرته منظمة "سام" عام 2023، ليس بسبب الحرب فقط، بل لأنهم لم يعودوا يجدون سبباً للبقاء في بلدٍ لا يقدّم التعليم، ولا الوظائف، ولا الأمل.
هذا الواقع يطرح سؤالا جوهرياً على دول الخليج: هل يمكن الاستمرار في التعامل مع اليمن كملف أمني عابر؟ أم أن التكلفة المتصاعدة للإهمال ستدفع نحو مراجعة الاستراتيجية؟ التجربة الأوروبية مع بولندا تؤكد أن بناء الجوار يحتاج إلى شجاعة في تبني رؤية متعددة الأبعاد، حيث يُدمج الاستثمار في الإنسان مع الإصلاح المؤسسي. اليمن، رغم كل تعقيداته، لا يزال يحتفظ بفرص يمكن استثمارها، لكن ذلك يحتاج إلى تحوّل جذري في النهج الخليجي، من منطق "الإنقاذ المؤقت" إلى "الشراكة الاستراتيجية". فكما حوّلت أوروبا جارتها الشرقية من منطقة نفوذ إلى شريك في النمو، يمكن للخليج أن يرى في اليمن ليس ساحة لصراع، بل جسراً نحو عمق إفريقي وآسيوي، إذا ما توفرت الإرادة لكتابة فصلٍ جديد في العلاقة، تُختصر فيه دروس الماضي، ويُفتح فيه الباب لمستقبلٍ مختلف.