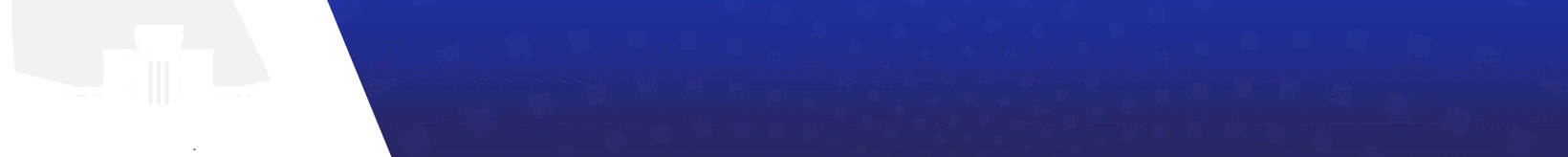من عدن إلى جيبوتي.. كيف فرت الصين من الحلم اليمني؟

محمد الجرادي
حين قرأت عن تعهد الصين بدعم دول أفريقية بـ51 مليار دولار، لم أندهش فالصين تفعل ما تعرفه جيدا: تستثمر في الفرص لا في الأمنيات، لكنني رغم ذلك، شعرت بوخزة قديمة. عادت بي الذاكرة إلى بداية 2014، حين كنت أعمل سكرتيرا إعلاميا لوزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي كنت شاهدا على محاولة لالتقاط واحدة من اللحظات النادرة في تاريخ بلادنا.
في ذلك العام جاء وفد صيني إلى صنعاء، إلى مبنى الوزارة المطل على شارع العدل بعد لقاء جمعهم مع رئيس الجمهورية ، كان الوفد يحمل خرائط ومجسمات ومخططات مكتملة لتطوير ميناء عدن، لم تكن زيارة بروتوكول، بل عرضا جادا ضمن مبادرة "الحزام والطريق": تحويل ميناء عدن إلى محطة محورية في شبكة التجارة العالمية التمويل من البنك الوطني الصيني والجدول الزمني واضح، والبداية كانت مقررة مطلع 2015.
وقد كان ذلك أحد المشاريع القليلة التي شعرت أن البلاد أخيرا تقترب من تحويل موقعها الجغرافي إلى قيمة اقتصادية. لكن كعادة اليمن مع الفرص فقد كان يكفي أن تسقط عمران، لينهار كل شيء سقطت الدولة وتبخر الحلم وانسحب الصينيون بهدوء كما يفعل المستثمرون حين يتأكدون أن الأرض لم تعد صالحة لزرع الثقة.
لا أنسى أنني خرجت بعد أحد الاجتماعات بين الوزير وطاقمه والوفد الصيني إلى مقهى العم نشوان في شارع هائل هناك حيث التقي بالأصدقاء، كنت أذرع الشوارع منتشيا أقول لهم، بحماسة ربما بدت طفولية: "الصين ستنهض بعدن… اليمن سيتغير" كنت أصدق ذلك لأنني رأيت الخرائط.
وفي هذا السياق، يجدر الإشارة إلى أن الثورات المضادة في تلك الفترة كانت تصعد بقوة في المنطقة وتستهدف بشكل ممنهج القوى الإسلامية التي تصدرت موجات الربيع العربي وكان لذلك تأثير مباشر على خيارات بعض الدول في اليمن وتوجهات بعض الأطراف المحلية المدعومة منها، والتي كانت ترى في إسقاط مشروع الدولة الاتحادية فرصة لإعادة تموضعها وإبقاء بلدنا في نظر العالم ملفاُ أمنيا لا اقتصادي قد يؤثر عليها ومصالحها.
وعندما طوي ملف عدن ذهبت الصين إلى الدولة الأخرى المطلة على باب المندب (جيبوتي) الدولة الصغيرة التي لم تكن تملك موقعا أفضل من عدن ولا موارد أهم، لكنها تملك ما فقدناه نحن: قرار سياسي واضح، واستقرار. والقرار والاستقرار ببساطة هو ما تبيعه الدول للمستثمرين وهو العملة الأندر في اليمن منذ عقود.
منحت جيبوتي للصين حق إنشاء قاعدة عسكرية مقابل 100 مليون دولار سنويا وفتحت الباب أمام استثمارات ضخمة في البنية التحتية مولت بكين مشاريع استراتيجية شملت موانئ ومطارات وخطوط سكك حديدية أبرزها خط كهربائي يربط جيبوتي بإثيوبيا بقيمة 4 مليارات دولار، إلى جانب شبكة أنابيب مياه بأكثر من 300 مليون دولار. كما أنفقت الصين مئات الملايين لتوسعة ميناء جيبوتي واستحوذت على نحو ربع ملكيته ومنذ 2015 ضخت الصين نحو 14 مليار دولار في جيبوتي في إطار رؤية لتحويلها إلى مركز تجاري يربط آسيا بأفريقيا.
وفي السياق ذاته، ذهبت الصين لتضع حجر الأساس لمنطقة اقتصادية في سلطنة عمان، إنها الدقم التي أصبحت اليوم من أعمدة الاقتصاد العماني. أما عدن فما زالت تدار بمنطق الفوضى لا بوصفها مدينة عريقة وميناء استراتيجي كان يوما ما حديث العالم.
ولطالما قلت إن اليمن لا يعيش فقرا تقليديا. هو يعيش مفارقة مؤلمة: بلد يطل على واحد من أهم الممرات المائية في العالم ولديه شريط ساحلي يتجاوز 2000 كيلو على بحرين، ويجاور أغنى دول العالم لكنه غارق في الأزمات ليس لأن الجغرافيا خذلته، بل لأن السياسة فعلت ذلك.
وللمقارنة، في باكستان رغم التحديات الأمنية بنت الصين ممر "جوادر" بتمويل يتجاوز 60 مليار دولار لأنه ورغم هشاشة الوضع هناك وجدت دولة. وفي إثيوبيا لم تجد البحر لكنها وجدت دولة أما في اليمن فكل شيء موجود… إلا الدولة للأسف.
أنا لا أقول أن الصين كانت حلما رومانسيا بل كانت فرصة اقتصادية ثمينة، عرض لا يمنح مرتين وكان بالإمكان اعتباره نقطة انتقال استراتيجي نحو دولة ذات اقتصاد متصل بالعالم لكننا كالعادة اخترنا طريق الانتحار البطيء قبلنا أن نكون مشاريع مضادة داخل بلدنا لممولين اقليميين.
فحين تغيب الدولة تحضر المشاريع الطاردة، في الشمال، برزت جماعة الحوثي التي ترى في وجود الدولة القوية تهديدا لمشروعها، فاليمن ليس مركزا بحريا بل منصة صواريخ. في خريطة الصين اليمن نقطة ارتكاز لوجستي في خريطة الحوثي اليمن ساحة تعبئة مذهبية، لم يكن الحوثي يعارض الميناء بحد ذاته بل كان يخشى ما قد يعنيه في سياق الدولة الاتحادية المقترحة فكرة الأقاليم بالنسبة له لم تكن مجرد تقسيم إداري بل تهديد استراتيجي مباشر لمشروعه لأنها كانت ستفصله عن البحر خاصة (ميدي وسواحل الحديدة)، كانت الأقاليم ستحرمه من منفذ تهريب بحري يصله بإيران وتهريب السلاح لهذا لم يرى في استقرار اليمن وشراكاتها مع العالم فرصة وطنية بل خطرا وجوديا فاختار خنق الدولة كلها بدلا من خسارة شريانه البحري.
وفي الجنوب، فالمشروع لا يقل ضبابية: شعور مزمن بالغبن تحول إلى فكرة انفصال بلا تصور سياسي أو اقتصادي، مشروع لا يطرح حكم محلي عادل بل يرفع علم بديل ويستنسخ مناطق نفوذ، لا يطلب حلول بل يبني جدارا بين الحل والواقع، وهكذا تحول اليمن إلى ساحة تزاحم فيها المشاريع الصغيرة على حساب المشروع الوطني لا الحوثي يمثل الشمال ولا المجلس الانتقالي يمثل الجنوب ولا أحد منهما قادر على مصافحة الصين أو التفاوض مع أي شريك دولي، فالدول لا تستثمر في خرائط تسيطر عليها الجماعات والمليشيات.
ورغم أن الصين لا تؤمن بالقوة الناعمة ولا تعبأ بالحريات إلا أنها تدرك أهمية الجغرافيا وتفهم كيف تحول الموانئ إلى نفوذ، هي تشبه تاجر مسلح بخيل بالعواطف لكنه يعرف بدقة أين يضع أمواله والشراكة معها لم تكن مشروع خلاص بل رافعة تنموية مؤقتة إن أحسنت الدولة استخدامها.
وأنا هنا لا أسوق للصين ولا أقول أنها كانت خيارا مثاليا ولا أدعي أنها نموذج يحتذى لكننا لسنا في موقع يسمح برفاهية الانتقاء فبلد مثل اليمن بحاجة إلى إعادة تشغيل اقتصاده والصين كانت وماتزال تملك أدوات التفعيل والإنقاذ، تخيل أنها ضخت في جيبوتي 14 مليار دولار وتعداد سكانه لا يصل مليون نسمة، بينما لا تستطيع أن تضخ في بلدك دولارا واحدا، لا شك أنه شعور مؤلم لكل من يهتم بمصلحة اليمن.
كما أنني لا أقول أن علينا استيراد نموذجها المغلق ولا تقليد نظام بلا حريات بل أن نتعلم منها كيف تبنى الخطط كيف نربط المصالح بالواقع لا بالأيديولوجيا والشعارات، وكيف نعيد تعريف النجاح بأنه بنية إنتاج لا خطابات ثورية وشعارات ما قبل الدولة. الصين لم تنهض لأنها دكتاتورية بل لأنها وضعت رؤية استراتيجية واشتغلت عليها بصبر تاريخي ونحن بحاجة إلى هذه الرؤية لتساعدنا وتخرجنا من هذا الوضع البائس. وفي المقابل، بينما كان علينا أن نأخذ من الصين عقلانية المصالح، كان علينا أن نأخذ من الغرب ما يليق بالأمم الحية: قيم الحكم الرشيد وسيادة القانون وحرية التعبير، احترام الإنسان، ومركزية العقد الاجتماعي. لسنا بحاجة إلى بدلاتهم أو شعاراتهم بل إلى فهم سر صمود مؤسساتهم، فالقوة لا تبنى بالدبابات بل بالقوانين العادلة التي تحمي الجميع من الجميع.
وقد جربنا في الماضي أوهام الاصطفاف حتى تخيل البعض أن المعسكر السوفيتي سينهض بنا والنتيجة: صراع داخلي في 1986 وحرب في 1994 وانقسامات وصراعات سياسية كلفت اليمن عقودا من الانهيار.
أنا كيمني أعشق الجغرافيا، لا يكاد يمر علي يوم دون أن أفتح جوجل ماب لأتأمل شكل بلدنا، وكأنني أبحث في خطوطه عن شيء أضعته في الطفولة أو ربما عن ذلك الحلم الذي كنا نردده في ساحات المدرسة ذات يوم ،أزور قريتي من الأعلى أتنقل بين طفولتي في الحقول ومدرستي، وأرى اليمن يطل على العالم بينما نختبئ منه وأتساءل: كيف لبلد بهذه الأذرع البحرية والجزر المتناثرة أن يعجز عن معانقة مستقبله؟
أحيانا أضع خريطة اليمن أمام ابنتي ليان التي لا تعرف اليمن بعد وأقول لها: انظري، هنا يمكن أن يكون لنا ميناء يشبه سنغافورة وهذه المنطقة في اليمن أجمل من هذه الجبال التي أمامك في سويسرا وتبتسم دون أن تفهم ماذا أعني بالضبط.
ولمن لا يعرف فتاريخيا كان اليمن عقدة الوصل بين الشرق والغرب، دولة الحميريين بعد الجفاف قامت على التجارة لا على الفتوحات، البخور واللبان اليمني وصل إلى معابد روما وأوروبا ظنت لقرون أن كل طيب يمني وحين لم يعد انتاج اليمن يكفي استوردنا من الهند والصين لنصدر للعالم تحت اسم منتج يمني.
وهنا ينبغي الإشارة إلى أن الحكومات المتعاقبة على اليمن لو فهمت الجغرافيا اليمنية كما هي تاريخيا، لأدركت أن ميناء المخا وليس عدن هو النقطة الأكثر حساسية على خط التجارة العالمي.
لكن المخا كان جوهرة البحر الأحمر حتى أهمله البريطانيون في صراعهم مع العثمانيين، وتم تحويله إلى ممر لتهريب السلاح والمخدرات إلى أفريقيا والداخل اليمني، وتوالت الحكومات اليمنية على تهميشه مركزة كل جهودها في عدن فقط.
اليمن بموقعه الجغرافي كان يجب أن يحتوي على خمس أو ست مناطق حرة وشبكة موانئ ومطارات تجارية حديثة كان يمكن أن نستقبل البضائع الآسيوية ونصدرها لأفريقيا وأوروبا ونكون عقدة التجارة البحرية في الإقليم بأكمله. لكن بدلا من ذلك تحولنا إلى بلد غارق في الحروب والصراعات والمشاريع الخارجية وتحولنا من عقدة وصل إلى حفرة نزاع ومن موقع استراتيجي إلى هامش منسي.
ومع ذلك، ما يزال لدينا فرصة وما ضاع في زمن الحرب يمكن استعادته في زمن السلام بشرط أن تعود الدولة بوصفها مشروعا سياديا لا شعارا مؤقتا أن تظهر سلطة تفكر بالمستقبل لا بالماضي وتعيد تقديم اليمن للعالم كما يستحق. الصين وسواها من القوى الدولية تبحث عن الشركاء القادرين وإذا استطاع اليمن بعد الحرب أن يقدم نفسه كدولة تملك القرار والرؤية، فإن الجغرافيا ذاتها التي خذلناها مرارا قد تكون بوابتنا للعودة.